سيميولوجيا الاتصال
Topic outline
-
 مقياس سيميولوجيا الاتصال هو مقياس ضمن وحدة تعليم استكشافية في المقرر الدراسي الموجه لطلبة السنة الثانية ليسانس تخصص علوم الاعلام والاتصال، يهتم بدراسة السيميولوجيا ضمن علاقته بالاتصال من خلال التطرق إلى مفاهيم عامة حولها ومعرفة نشأتها وتطورها وعلاقتها بعلوم الاعلام والاتصال ، بالإضافة إلى دراسة خطوات التحليل السيميولوجي الذي يبحث في دلالة العلامات داخل الأنساق واستنطاقها عبر آلية تأويلية خاصة تستند إلى إجراءات و أدوات الشيء الذي يجعل منه تحليلا مميزا. مما يكسب طالب التخصص الادوات التي تمنكنه من نقد المضامين الاعلامية والاتصالية .
مقياس سيميولوجيا الاتصال هو مقياس ضمن وحدة تعليم استكشافية في المقرر الدراسي الموجه لطلبة السنة الثانية ليسانس تخصص علوم الاعلام والاتصال، يهتم بدراسة السيميولوجيا ضمن علاقته بالاتصال من خلال التطرق إلى مفاهيم عامة حولها ومعرفة نشأتها وتطورها وعلاقتها بعلوم الاعلام والاتصال ، بالإضافة إلى دراسة خطوات التحليل السيميولوجي الذي يبحث في دلالة العلامات داخل الأنساق واستنطاقها عبر آلية تأويلية خاصة تستند إلى إجراءات و أدوات الشيء الذي يجعل منه تحليلا مميزا. مما يكسب طالب التخصص الادوات التي تمنكنه من نقد المضامين الاعلامية والاتصالية . -
 الجامعة
الجامعة جامعة وهران1 الكلية كلية العلوم الانسانية والعلوم الاسلامية القسم علوم الاعلام والاتصال المستوى السنة ثانية ليسانس التخصص علوم الاعلام والاتصال المقياس سيميولوجيا الاتصال الاستاذ كروش نوال نوع الدرس محاضرة +أعمال موجهة السداسي / الحجم الساعي الاول / سا و30د محاضرة +ساو 30داعمال موجهة طريقة التقييم المراقبة المستمرة +الامتحان الكتابي -
استاذة كروش نوال ، دكتورة في علوم الاعلام والاتصال
الايميل : nawalkerrouche02@gmail.com

-
 يهدف المقياس الى تحقيق النقاط التالية :
يهدف المقياس الى تحقيق النقاط التالية : _تشجيع الطلبة على التوجه في البحث عن خصوصية العلامة في علوم الاعلام والاتصال .
_تدعيم البحث النظري والمنهحي حول الممارسات السيميائية وطبيعة وقواعد استخدام الدلائل الرمزية في عملية الاعلام والاتصال .
_اثراء مجال الدراسات الاتصالية بادوات ومعارف التحليل السيميولوجي واكساب الطالب مهارة القراءة النقدية للمضامين التصالية والاعلامية
-

كل الطلبة الذين تحصلوا على محتلف المعارف في تخصصات مختلفة في تكوين السنة الاولى جذع مشترك نظام (أل مد) خاصة العلوم الانسانية وعلوم الاعلام والاتصال
-

-
 المحاضرة الاولى نتطرق فيها إلى أهم المفاهيم المتعلقة بالسميولوجيا مثل السيمياء السيميوطيقا واللسانيات
المحاضرة الاولى نتطرق فيها إلى أهم المفاهيم المتعلقة بالسميولوجيا مثل السيمياء السيميوطيقا واللسانيات -
https://atharah.net/introduction-to-semiotics/
خلال هذه المحاضرة نركز على اهم المراحل التي شهدتها السيميولوجيا في تطورها التاريخي والمعرفي
تجدون في هذا الرابط المرفق معلومات مفصلة لهذه المراحل للباحث : عبد الاله آل عمران
-
تعتبر علوم الإعلام و الاتصال من العلوم التي تعنى بدراسة العمليات الاتصالية التي نشأت إثر عدة محاولات بحثية جادة من طرف باحثين من حقول معرفية مجاورة أساسا من علم الاجتماع من خلال أعمال رواد المدرسة الوظيفية التي أسست للتيار الوضعي و نادت بضرورة دراسة الظواهر الإنسانية و الاجتماعية وفق خطوات المنهج التجريبي، بالإضافة إلى إسهامات حقول معرفية أخرى من بينها السيميولوجيا العامة التي دعمت علوم الإعلام و الاتصال من خلال مفاهيم جديدة و مناهج كيفية من أجل دراسة العلامات الاتصالية بمختلف أنساقها و ذلك ما تجسد في سيميولوجيا الاتصال و تطبيقاتها المختلفة، و كل انتاجات الفن و الرسائل الثقافية التي برزت من خلال الصناعات الثقافية الجماهيرية.
أهمية السيميولوجيا في علوم الإعلام والاتصال
1. السيميولوجيا اللغوية
التعريف دراسة العلامات اللغوية وكيفية استخدامها لنقل المعاني في سياقات اجتماعية وثقافية.
المكونات (حسب فرديناند دي سوسير):
- الدال الشكل المادي للكلمة (صوت أو رمز مكتوب).
- المدلول المعنى المرتبط بالكلمة.
التطبيقات
- تحليل النصوص الأدبية والإعلامية.
- فهم الخطاب السياسي والتأثير على الرأي العام.
- تحليل التواصل الشفهي اليومي.
الأهمية تساعد على فهم بناء المعاني وتأثير العوامل الثقافية في تفسير العلامات.
2. السيميولوجيا البصرية
التعريف دراسة الصور والألوان والأشكال كرموز بصرية لنقل المعاني.
المكونات
- الدال: العنصر المرئي (مثل الصورة أو اللون).
- المدلول: المعنى المرتبط بهذا العنصر.
التطبيقات
- - تصميم الإعلانات التجارية.
- - تحليل الأفلام والفنون البصرية.
- - فهم تأثير الصور في وسائل التواصل الاجتماعي.
الأهمية تكشف كيفية تأثير الرموز البصرية في التفكير والسلوك.
3. السيميولوجيا السمعية
التعريف دراسة الأصوات والموسيقى كرموز سمعية لنقل المعاني.
المكونات
- الدال الصوت أو التردد السمعي.
- المدلول المعنى أو الشعور المنقول.
التطبيقات
- - تحليل الموسيقى والمؤثرات الصوتية في الأفلام.
- - تصميم إعلانات تستخدم الأصوات لجذب الانتباه.
- - فهم الإشارات الصوتية مثل الإنذارات.
الأهمية توضح كيفية تفسير الأصوات وتأثيرها النفسي والثقافي.
4. سيميولوجيا التواصل غير اللفظي
التعريف دراسة الإيماءات ولغة الجسد وتعابير الوجه في التواصل.
المكونات
- لغة الجسد، تعابير الوجه، التواصل البصري، المسافة الشخصية، نبرة الصوت.
التطبيقات
- - تحسين التفاعل في العلاقات الشخصية والمهنية.
- - فهم الأداء المسرحي والفني.
- - تجنب سوء الفهم في التواصل بين الثقافات.
الأهمية: تكشف الرسائل المخفية وراء الكلمات وتحسن التفاعل البشري
المراجع:
1. دي سوسير، فرديناند. (1916). *محاضرات في علم اللغة العام*. (أساسيات الدال والمدلول).
2. بارت، رولان. (1964). *عناصر السيميولوجيا*. (تطبيقات السيميولوجيا في تحليل النصوص والصور).
3. إيكو، أمبرتو (1976). *نظرية السيميولوجيا*. (العلامات البصرية والسمعية).
4. هال، إدوارد. (1966). *البعد الخفي*. (التواصل غير اللفظي والمسافة الشخصية).
-
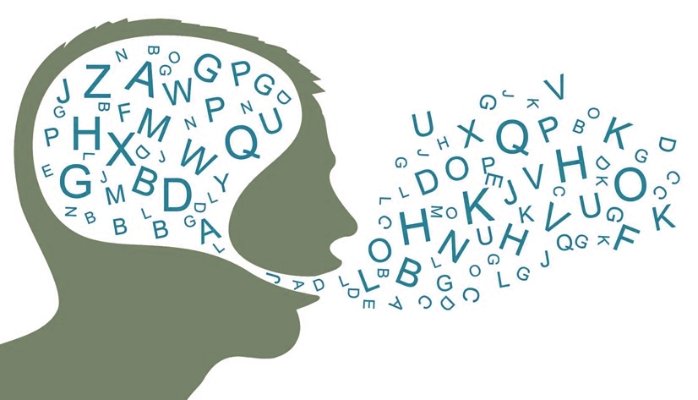 خلال هذه المحاضرة سنسلط الضوء على علاقة السيميولوجيا مع كل من اللسانيات و الاتصال بالتركيز على طرح سوسيور وسيميولوجيا التواصل
خلال هذه المحاضرة سنسلط الضوء على علاقة السيميولوجيا مع كل من اللسانيات و الاتصال بالتركيز على طرح سوسيور وسيميولوجيا التواصل أهم المراجع التي يمكن الاعتماد عليها فيما ورد في الملف:
1. فرديناند دي سوسير (Ferdinand de Saussure)
محاضرات في علم اللغة العام* (1916).
2. رولان بارت (Roland Barthes)
عناصر السيميولوجيا* (1964).
3. رومان جاكبسون (Roman Jakobson)
علم اللغة واللسانيات* (مقالات مختارة).
4. جورج مونان (Georges Mounin)
السيميولوجيا التواصلية* (1970).
5. إريك بويسنس (Eric Buyssens)
اللسانيات والسيميولوجيا* (1943).
6. لويس بريتو (Luis Prieto)
رسائل في السيميولوجيا* (1966).
7. تشارلز ساندرس بيرس (Charles Sanders Peirce)
مقالات في السيميائية* (مجموعة مقالات).
8. أمبرتو إيكو (Umberto Eco)
النظرية العامة للسيميولوجيا* (1976).
-
المنهج البنيوي والسيميائي1. المنهج البنيويالتعريف:البنيوية منهج نقدي يركز على تحليل النص الأدبي كبنية مستقلة بذاتها، منفصلة عن السياقات الخارجية مثل المؤلف أو المجتمع أو التاريخ.المفاهيم الأساسية:ثنائية الدال والمدلول (فرديناند دي سوسير): الدال هو الشكل المادي (كلمة/صوت)، والمدلول هو المعنى الذهني المرتبط به.الوظائف اللغوية (رومان جاكوبسون): مثل الوظيفة الشعرية التي تُبرز "أدبية الأدب".النص كبنية عضوية: وحدة متكاملة تخضع لقوانين داخلية (كاللغة).ايجابيات البنيوية- الدقة في تحليل النص عبر التركيز على عناصره الداخلية.- تحرير النقد من التفسيرات التاريخية أو النفسية التقليدية.سلبيات البنيوية- إهمال السياق الاجتماعي والتاريخي.- التعامل مع النص ككيان معزول، مما يحد من فهمه الشامل.2. المنهج السيميائيالتعريفعلم يدرس العلامات (اللغوية، البصرية، السمعية) وأنظمة التواصل، كتطور للبنيوية مع التركيز على الدلالة والمعنى.المفاهيم الأساسيةالعلامة تتكون من الدال (الشكل) والمدلول (المعنى) والوظيفة القصدية.البنية السرديةتحليل الحكايات عبر الوظائف الثابتة (كما في نموذج فلاديمير بروب للحكايات الشعبية).تطبيقات السيميائية- تحليل النصوص الأدبية والإعلانات والسينما عبر أنظمة العلامات.- دراسة التفاعل بين العلامات في سياقات ثقافية مختلفة.انتقادات السيميائية- إهمال العوامل الاجتماعية والثقافية في بعض التوجهات.- التركيز المفرط على الشكل بدلًا من المضمون.3. العلاقة بين البنيوية والسيميائيةالتكامل- السيميائية توسع نطاق البنيوية لدراسة أنظمة العلامات غير اللغوية (كالصور والأصوات).- كلاهما يركزان على البنية الداخلية للنصوص والأنظمة الدلالية.الاختلاف- البنيوية أكثر ارتباطًا باللسانيات، بينما السيميائية أوسع (تشمل الثقافة والاتصال).4. إنجازات ونقائصالإنجازات- تطوير أدوات تحليلية دقيقة للنصوص والأنظمة الثقافية.- كشف الأبنية الخفية في النصوص (كالأساطير والأيديولوجيات).النقائص- إغفال دور القارئ والسياق في إنتاج المعنى (كما في النقد التأويلي).- صعوبة تطبيقها على النصوص الديناميكية أو المتغيرة.خلاصة :البنيوية والسيميائية مثّلتا تحولًا جذريًا في النقد الأدبي بالانتقال من دراسة المضمون إلى دراسة الشكل والبنية، لكنهما واجهتا انتقادات بسبب إهمالهما للسياق التاريخي والاجتماعي.---المراجع :1. **فرديناند دي سوسير**: *محاضرات في علم اللغة العام*.2. **رولان بارت**: *عناصر السيميولوجيا*.3. **رومان جاكوبسون**: نظريات التواصل والوظائف اللغوية.4. **فلاديمير بروب**: *مورفولوجيا الحكاية* (تحليل الوظائف السردية).5. **أمبرتو إيكو**: *النظرية العامة للسيميولوجيا*.
-
-
مفهوم الدليل اللساني عند دي سوسير
في بداية حديثه عن الدليل اللساني Le signe linguistique ينتقد دي سوسير الرأي القائل بأن اللغة في جوهرها هي مجرد عملية لتسمية الأشياء ليس إلا، ويضرب مثالا برسم لشجرة وحصان وتسمياتهما "شجرة" "حصان"، معتبرا أن الاعتقاد ببساطة هذا الفعل في النظام اللغوي لا أساس له من الصحة .
إذن، فالدليل اللساني كيان نفسي بوجهين كما هو موضّح في الشكل التالي: صورة سمعية
وعنصرا الدليل، المفهوم والصورة السمعية، مرتبطان بشكل وثيق؛ بحيث كل واحد منهما يوحي بالآخر. إن القارئ لمحاضرات دي سوسير يتضح له جليًّا تدقيقه لمصطلح "دليل"، إذ يعني به تلك الوحدة المكوَّنة من مفهوم وصورة سمعية مميّزا له بذلك عن التصور العام الذي لا يعدّه سوى صورة سمعية .
ولمعالجة هذا الإشكال المصطلحي المفاهيمي احتفظ سوسير بمصطلح "دليل" Le signe قاصدا به مجموع هذين المكونين؛ مدلول
دليل دال
ثم استبدل المفهوم بالمدلول Signifié، والصورة السمعية بالدالSignifiant5).
وحري بالذكر هنا أن عنصرا الدليل يتكون كل واحد منهما من شقّين:
- 1-جانب مادي وينضوي على:
- الموجود الخارجي أو الشيء.
- اللفظ المنطوق بالفعل الذي يتألف من أصوات واقعية.
- 2-جانب ذهني ويضم:
- المفهوم أو الصورة الذهنية للموجود الذي يشار إليه بلفظ معين.
- الصورة السمعية، أي صورة اللفظ نفسه التي نتمثلها إذا نظرنا إلى كلمة ما مكتوبة دون أن ننطق بها.
عن الرمز؛ وذلك لتوفر هذا الأخير على توافق بين داله ومدلوله فإذا كانت الحمامة رمزا للسلام وليس النسر أو الديك فهذا راجع إلى خصائصها الطبيعية والتي ترسّخت في الثقافات البشرية، ونفس الأمر بالنسبة للميزان التقليدي الذي يرمز به للعدالة دون غيره من وحدات القياس المتعارف عليها، فجعله -هو بالتحديد- رمزا للعدالة راجع إلى خصائصه التقنية التي تقضي بتسويته لكفّتيه في مستوى واحد، فنقلت هذه الخاصية إلى الثقافة البشرية وص
مفهوم الدليل عند بيرس
مدخل فلسفي شامل حول نظرية بيرس في العلامة؛ نص مترجم، ومنشور على (موسوعة ستانفورد للفلسفة). ننوه بأن الترجمة هي للنسخة المؤرشفة في الموسوعة، والتي قد يطرأ عليها التعديل من منذ تتمة هذه الترجمة. وختامًا، نخصّ بالشكر محرري موسوعة ستانفورد على تعاونهم واعتمادهم للترجمة والنشر على مجلة حكمة
نظرية بيرس في العلامة، أو السيميوطيقا، هي عمل يتعلق بالدلالة، والتمثيل، والمرجع، والمعنى. على الرغم من أن لنظريات العلامة تاريخ طويل، إلا أن أعمال بيرس تعد مميزة ومبتكرة من حيث اتساعها وتعقيدها، وفي التقاط أهمية التأويل للدلالة. بالنسبة لبيرس، كان تطوير نظرية شاملة للعلامات هو شغله الشاغل في المجالين الفلسفي والفكري. أهمية السيميوطيقا بالنسبة لبيرس واسعة النطاق.
علم العلامات: Semiotics مشتق من الكلمة اليونانية sema < semeion وتعني "علامة" وهو علم يعنى بدراسة وتصنيف جميع أنواع العلامات والإشارات بما فيها العلامات اللغوية. يقول الفيلسوف الأمريكي Pierce : ليس باستطاعتنا أن ندرس أي شيء في هذا الكون – كالرياضيات والأخلاق والعادات والفلك والجاذبية والكيمياء والكلام إلا على أنها أنظمة سيميولوجية (إشارية).
أنواع العلامة:
وقد ميّز بيرس Pierce ثلاثة أنواع من العلامات، هي العلامة الأيقونية، والعلامة الإشارية، والرمز. وفيما يلي سنوضح هذه الأنواع الثلاثة:
العلامة الأيقونية Iconic Sign : العلامة التي تبين مدلولها عن طريق المحاكاة، مثل صور الأشياء، والرسوم البيانية، والخرائط، والنماذج، والمجسمات.
العلامة الإشارية Indexical Sign : العلامة التي تشير إلى مدلول لعلاقة تلازمية، مثل الدخان في دلالته على وجود النار، وآثار الأرانب والحباري في دلالته على وجود هذه الحيوانات، وآثار المجرم في دلالتها على تورطه في جريمته، الحبوب التي تظهر على الجسم عند المصاب بالحصبة أو الجدري.
الرمز: Symol : العلامة التي تفيد مدلولها بناء على اصطلاح بين جماعة من الناس، مثل: إشارات المرور الضوئية، وعلامة صح √ وعلامة خطأ X وعلامات الموسيقى ♫ ومفردات اللغة مثل: شجرة، حصان، كتاب، صدق، قتل. وأصوات الأبواق والأجراس.
مفهوم الدليل في سيميولوجيا "بارث"
يعتبر رولان بارت خير من يمثل هذا الاتجاه، لأن البحث السيميولوجي لديه هو دراسة الأنظمة والأنسقة الدالة. فجميع الوقائع والأشكال الرمزية والأنظمة اللغوية تدل. فهناك من يدل باللغة وهناك من يدل دون اللغة المعهودة، بيد أن لها لغة خاصة. وما دامت الأنساق والوقائع كلها دالة، فلا عيب من تطبيق المقاييس اللسانية على الوقائع غير اللفظية أي الأنظمة السيميوطيقية غير اللسانية لبناء الطرح الدلالي.
والمدلول، والمركب والنظام، والتقرير والإيحاء (الدلالة الذاتية والدلالة الإيحائية).
أما عناصر سيمياء الدلالة لدى بارت فقد حددها في كتابه«عناصر السيميولوجيا»، وهي مستقاة على شكل ثنائيات من اللسانيات البنيوية وهي: اللغة والكلام، والدال والمدلول، والمركب والنظام، والتقرير والإيحاء (الدلالة الذاتية والدلالة الإيحائية).
وهكذا حاول رولان بارت التسلح باللسانيات لمقاربة الظواهر السيميولوجية كأنظمة الموضة والأساطير والإشهار... الخ
ويعني هذا أن رولان بارت عندما يدرس الموضة مثلا يطبق عليها المقاربة اللسانية تفكيكا وتركيبا من خلال استقراء معاني الموضة ودلالات الأزياء وتعيين وحداتها الدالة ومقصدياتها الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والثقافية. والشيء نفسه في قراءته للطبخ والصور الفوتوغرافية والإشهار واللوحات البصرية.
يمكن إدراج المدارس السيميائية النصية التطبيقية التي تقارب الإبداع الأدبي والفني ضمن سيميولوجيا الدلالة، بينما سيميوطيقا الثقافة التي تبحث عن القصدية والوظيفة داخل الظواهر الثقافية والإثنية البشرية يمكن إدراجها ضمن سيميولوجيا التواصل. ولتبسيط سيميولوجيا الدلالة نقول: إن أزياء الموضة وحدات دالة إذ يمكن أثناء دراسة الألوان والأشكال لسانيا أن نبحث عن دلالاتها الاجتماعية والطبقية والنفسية. كما ينبغي البحث أثناء تحليلنا للنصوص الشعرية عن دلالات الرموز والأساطير ومعاني البحور الشعرية الموظفة ودلالات تشغيل معجم التصوف أو الطبيعة أو أي معجم آخر.
-
-
مفهوم الخطاب البصري:
يتألف مصطلح الخطاب البصري من مصطلحين: الخطاب والصورة،
فالخطاب يمثل لغة يتم من خلالها الاتصال بالأخر اذ تصدر هذه اللغة من مرسل إلى مستقبل وعادة ما تكون بصيغة ألفاظ أو إشارة أو ايماءة أو حركة أو صوت بهدف المرسل من وراء هذه اللغة إلى اخبار وتبليغ المستقبل بشيء ما أو حدث ما أو بخبر ما.
أما خطاب الصورة فهو الاتصال الحادث بين المرسل والمستقبل عبر وسيط مرئي بهدف تبليغه لرسائل تنطوي على مضمون معين فخطاب الصورة هو تبليغ الاخر برسائل معينة عبر الصور. إن كلمة الصورة المشتقة من الكلمة اللاتينية "Imago" مصدرها السيميولوجي "Imatari"، التي تعني التماثل مع الواقع وبهذا يصبح معنى الصورة سيميولوجيا "كل تصوير يرتبط مباشرة بالمرجع الممثل بعلاقة التشابه المظهري أو بمعنى أوسع كل تقليد الرؤية في بعدين "رسم وصورة" أو في ثلاث أبعاد "نقش، فن، التماثل" وهي دعامة أو سند الاتصال البصري، تجسد مقتطفًا من المحيط المدرك "الواقع"، قابلة للدوام والاستمرار على مر الوقت، وتنقسم عمومًا إلى صور ثابتة ومتحركة
خصائص الخطاب البصري:
- أنه لا يقبل التقطيع المزدوج فهو عبارة عن وحدة شاملة، حيث أنه يؤسس أنظمة متعددة بعضها أيقوني خالصة لأن تمفصلاته لا تقع على الدال دون المدلول لتقاربهما على عكس الخطاب اللفظي. فإمكانية صنع الرموز وصياغة الدلالات وتجسيد القيم لما يحتويه من عناصر تعبيرية سواء تمثلت فيما هو شكلي، أو لوني، أو حجمي، أو جمالي.
- الاختصار والشمولية وهما صفتان في الخطاب البصري الذي يختصر عدة صفحات من الكتابة في خطاب واضح وشامل. حيث لا يستند الخطاب البصري في انتاج دلالته إلى عناصر أولية مالكة لمعاني سابقة، وانما يستند إلى تنظيم يستحضر السنن التي تحكم الأشياء في بنيتها الأصلية.
- الخطاب البصري منفتح على عدة تأويلات وذلك باختلاف قدرات المدركين، ويستند إلى خاصية التعليل، والمماثلة والتشابه
أنواع الخطاب البصري:
تنوعت الخطابات البصرية فيما يأتي:
- الخطاب الإشهاري: يعد صناعة إعلامية وثقافية بأتم معنى الكلمة، فيحظى باهتمام كبير في مختلف المجتمعات وخصوصًا المتطورة منها، لما يتميز به من قدرة عالية على بلورة الرأي وتشكيل الوعي وفي التأثير على الثقافة وتوجيهها في أبعادها المختلفة الأخلاقية والفلسفية.
- الخطاب الفني: ارتبط الخطاب الفني منذ ظهوره بالأعمال اليدوية ولم ينظر له كفن يملك جمالية إلا في اللحظة التي أصبح فيها نشاطًا ثقافيًا، حيث أنه عرف في بداياته الأولى كخطاب بسيط يحاول أن يماثل بين الحقيقة والواقع ولم يكون سوى وسيلة للتصوير، ومحاولة تقليد الطبيعة سواء بتشكيل بعض الايقونات أو بخط بعض الصور على الكهوف والمغارات، فالهاجس الأول الذي ربط الإنسان بالفن هو الخوف الدائم مما هو غيبي وسرعان ما تطورت وتيرة الحياة باكتشاف وسائل الاتصال من مطبعة وورق ووسائل اتصالية أخرى.
- الخطاب الفوتوغرافي: هو عبارة عن علامة تمتلك بعض خصوصيات الموضوع الممثل في تحديده للأيقونة إذ إن هذا الخطاب يمتلك دلالة خاصة بامتزاجه مع الخطاب اللفظي الإعلامي فهدفه توصيل الرسالة من مرسل إلى متلقي، بأقل قدر من التحريف والتشويش الذي يقلل من مصداقيته إن أكتشف المتلقي ذلك، إذ أنه يخضع إلى ضوابط خمسة: من؟ ماذا؟ أين؟ متى؟ أين؟
- الخطاب الذهني: يعتبر نشاط ذهني باطني يقوم الفرد من خلاله بتخيل وتركيب وبناء مجموعة من الأفكار والتخيلات وسجها لتكون على شكل خطاب ذهني، يتميز بالأحادية في الإنتاج أو حتى في الإرسال.
- الخطاب السينمائي: هو خطاب ابداعي فني ولغة خاصة توظف عدة عناصر لإنجازها "الكاميرا، سلم اللقطات، المؤثرات الخاصة.." والمونتاج الذي يعد عملية هامة في إنجاز هذا الخطاب ويتم بموجبه تركيب اللقطات لإنجاز جسم ذا معنى ودلالة "فيلم".
- الخطاب الكاريكاتيري: هو نص سيميائي حسب السيميولوجيين الذي يتبنون فكرة أنه لا شيء خارج النص، وتعد الأشكال المحورة جزء لا يتجزأ منه، لها قدرة دلالية قادرة على بعث الفكرة في زمن قياسي مقارنة بالزمن الذي يستغرقه القارئ في إدراك اللغة، يتسم بالبساطة والتلقائية، وهو خطاب مفتوح للمتلقي بغض النظر عن مستواه الثقافي
-
-
تدون في المطبوعة أدناه كل ما يتعلق بالمحاضرة 12و 13
بالتوفيق
-
 - فايزة يخلف، سيميائيات الخطاب والصورة، دار النهضة العربية، بيروت، 2012.
- فايزة يخلف، سيميائيات الخطاب والصورة، دار النهضة العربية، بيروت، 2012.- دليلة مرسلي و آخرون ،ترجمة عبد الحميد بورايو، مدخل إلى السيميولوجيا: (نص-صورة)، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،1995.
- عبد القادر فهيم الشيباني ، معالم السيميائيات العامة ، أسسها و مفاهيمها ، ط1 ، الجزائر ، 2008
- عصام خلف ، الاتجاه السيميائي و نقد الشعر ،ط 1 ، دار فرحة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2003
- عبد الله ثاني قدور ، تشكيل رسوم الاطفال و اشكالية سيميولوجيا الاتصال في الفن التشكيلي المعاصر ، ط1،دار الغرب ، الجزائر، 1996
- هامل بن عيسى ، السيميائية : أصولها المنهجية و اتجاهاتها التطبيقية ،ط1 ، مطبعة رويغي ، الجزائر ، 2007
- حبيب بوزوادة ، علم الدلالة و التأصيل و التفضيل ، مكتبة الرشاد للطبع و النشر ، ط1 ، الجزائر ، 2008
- امبيرتو ايكو ، ترجمة سعيد بن كراد ، العلامة : تحليل المفهوم و التاريخ ، ط1 ،المركز الثقافي العربي ، المغرب ، 2007
- جيرار دولودال ، ترجمة عبد الرحمن بوعلي ، السيميائيات أو نظرية العلامات ، ط1 ، مطبعة النجاح الجديدة ، 2000
- عبد القادر عبد الجليل ، علم اللسانيات الحديثة ، ط 1 ،دار صنعاء للنشر و التوزيع ، الأردن ، 2002
- كعب حاتم ، الملامح السيميائية في القصة الموجهة للطفل الجزائري : قصص الحيوان لمحمد ناصر أنموذجا ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، جامعة الجزائر ، 2007-2008
Ferdinand de Saussure : Cours de linguistique générale, éd Payot, Paris, 1972
Louri lotman , boris ouspenski , sémiotique de la culture russe , Edition l’age d’homme, laussane,1990
Greimas . A . J, Courtes, Sémiotique, dictionnaire raisonné de la théorie de langage n01 Paris , hachette, université.

